“الأخلاق في عصر الحداثة السائلة”

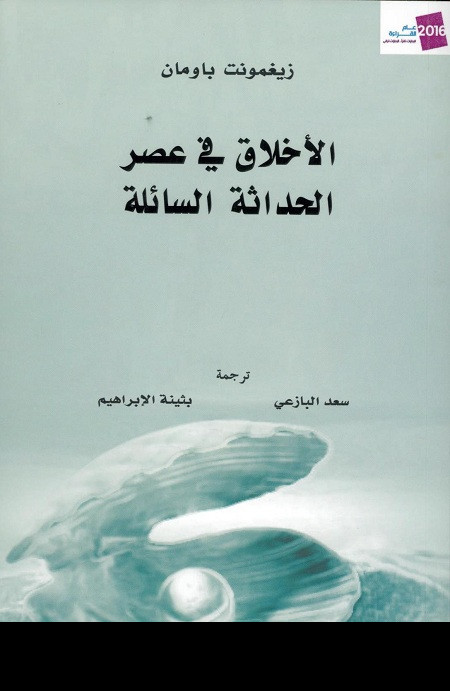
بقلم: محمد يسري أبو هدور* — ولد زيغموند باومان في بولندا عام 1925م، ودرس علم الاجتماع في مرحلة دراسته الجامعية، وعمل بعد تخرجه أستاذاً جامعياً في هذا التخصص، وفي عام 1971م خرج مطروداً من بلده، بعد أن عارض النظام الشيوعي القائم بها، واستقر في إنجلترا، حيث عمل أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة ليدز.
وقد عُرف عن باومان اهتمامه وتخصصه في دراسات الحداثة والظواهر والتجليات المرتبطة بها في العالم المعاصر عموماً، وفي المجتمعات الغربية على وجه الخصوص.
يقّسم باومان الحداثة إلى طورين متمايزين: الطور الأول، وهو ما يسمّيه باسم (الحداثة الصلبة) وهي تلك التي تم تدشينها في عصر التنوير في أوروبا القرن الثامن عشر، وتمخضت عنها مفاهيم كبرى مثل (الدولة الحديثة-المجتمع-الثقافة).
أما الطور الثاني، فهو ما يسمّيه باسم (الحداثة السائلة)، وهي التي برزت على السطح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن العشرين، ويسمّي الكثير من الباحثين تلك المرحلة باسم (ما بعد الحداثة). أما باومان فقد أعتاد أن يصفها بالحداثة السائلة، بسبب اعتقاده بأن صلابة المرحلة السابقة قد ذابت وتفككت بفعل الكثير من العوامل والعناصر المتداخلة، مما نشأ عنه حدوث (تداخل في الحدود وتراخت السمات وازدادت ضبابية وتشابهت).
وقد أولى باومان في أبحاثه المتعددة اهتماماً كبيراً بتوصيف سمات عصر الحداثة السائلة، فكانت من أهم الكتب التي نشرها والتي تعلقت بذلك الموضوع (الحداثة السائلة، الحب السائل، الأخلاق السائلة).
في كتابه (الأخلاق السائلة) الذي نشره مشروع “كلمة” في أبوظبي في عام 2016م، يتطرق باومان إلى جانب معيّن من الجوانب الأخلاقية في عصرنا الحالي، وكيف تغيرت القيم والمعايير الأخلاقية المتعارف عليها من قبل، تحت وطئة أسلوب الحياة المتبع حالياً.
في مقدمة الكتاب، يطرح باومان سؤال مفتاحياً حول المنهج الذي سيتبعه في دراسته تلك. فهو يؤكد أنه لن يلجأ في الكثير من الأحيان إلى المفاهيم الجديدة المتعارف عليها في الأوساط البحثية والأكاديمية، وأنه سيستبدل بعضاً منها بمفاهيم ومصطلحات أخرى قد تساعده في توصيل أطروحته إلى القارئ بشكل أكثر انضباطاً ودقة، ويظهر ذلك بشكل واضح في قوله (إن عادتنا القديمة والمصرة على البقاء في تنظيم توازن القوى بالاستعانة بأدوات مفاهيمية مثل المركز والأطراف، والسلم الهرمي، والأولوية والثانوية، هي أقرب إلى أن تكون معيقة من أن تكون معينة لنا، أن تكون معمية من أن تكون ضوءاً يقودنا).
وفي الحقيقة، إن القارئ المتعمق لفكر باومان من خلال أبحاثه وكتاباته، لن يندهش من ذلك التصريح، بل وسيجده متسقاً ومتوافقاً مع الرؤية الكلية لباومان، فأحد أهم العوائق التي تضعها الحداثة أمام دارسي ظواهرها، أنها تُعطي لهم بعض الأدوات البحثية والمفاهيمية الحداثية لدراستها، وهو ما يعني بالتبعية عدم القدرة على الإلمام بكامل الظاهرة ولا على الغوص في أعماقها لتفكيكها وتفنيد عوامل ظهورها وتأثيراتها.
ولهذا فإن باومان يلفت نظر القارئ إلى عدد من المصطلحات التي سيستخدمها خلال البحث، والتي قد تكون جديدة بشكل كلي بالنسبة للقارئ الذي لم يعتد التعامل مع أفكار ورؤى باومان من قبل.
من أهم تلك المصطلحات (التكافؤ، الشبكة، الاتصال والانفصال)، ولا يقدم باومان تعريفاً مفصلاً لكل مصطلح منهم في المقدمة، بل أنه يترك ايضاح كل مصطلح عند تناوله بشكل عفوي خلال البحث.
الأخلاق والمجتمع
يؤكد باومان أن طبيعة المجتمع من حيث كونه شكلاً من أشكال التجمع البشري، قد أدت إلى بروز وسيطرة إرادة جمعية معيّنة هيمنت وطغت على الإرادات الفردية.
فإذا ما افترضنا وجود علاقة ثنائية قائمة ما بين فردين لا ثالث لهما، فمن المؤكد أنه سوف يكون هناك بروز للجوانب الفردية في شخصية كل منهما، وهو الأمر الذي سيتبدل تماماً بمجرد دخول فرد ثالث في العلاقة، لأنه وقتها سوف تكون هناك أغلبية وأقلية، وسوف تهيمن الأغلبية وتحد من تأثير وقوة الفردية، (وبهذا الشكل فإن الأغلبية يقللون من قيمة التفرد، والقرب المميّز، والأولويات التي لا تنافس، والمسؤوليات غير المشروطة، كل تلك اللبنات التي تشكّل أساس العلاقات الأخلاقية).
ويربط باومان بين جميع أساليب وأشكال العمران والتحضّر البشري من جهة ومفهوم القسر وتحدي النزعة الفردية المتأصلة في الإنسان من جهة أخرى، فبحسب ما يقول (إن الحضارة بلا قسر غير متصورة).
ويرى الكاتب أن تلك القاعدة قد أصابها الكثير من التبديل والتغيير في عصر ما بعد الحداثة الذي نعيش فيه الآن، (فقد حلّت الإثارة محل القسر، والإغراء محل الفرض العنيف للأنماط السلوكية، والعلاقات العامة والإعلان محل المراقبة البوليسية للسلوك، وإثارة احتياجات ورغبات جديدة محل الضبط المعياري بصفته تلك).
إذن، يرى باومان أن الأسس والدوافع التي تعمل على شرعنة وجود المجتمع في عصر الحداثة السائلة، تختلف بشكل كامل مع فرضية الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز التي ترى حتمية وجود المجتمع حتى لا تحدث حرب (من الكل ضد الكل)، وإن كانت تلك الدوافع الجديدة تتفق في المضامين والغايات والنهايات مع الدوافع التي أوردتها النظرية الهوبزوية.
ومن النقاط المهمة التي ينتبه لها المؤلف، أثناء تمييزه ما بين ملامح كل من المنظومة الأخلاقية في عصر الحداثة الصلبة ومثيلتها في عصر الحداثة السائلة، هي نقطة (الشعور بالمسؤولية)، فبينما كانت النظم البيروقراطية السلطوية تعمل على إحداث (إزاحة مشاعر) فيما يخص الشعور بالمسؤولية، ليتم التركيز على رأس النظام أو رأس الدولة، وليشعر الفرد بالراحة لكون المسؤولية ليست ملقاة على عاتقه، فإن أنظمة الحداثة السائلة قد عملت على تثبيت فكرة المسؤولية على كل فرد في المجتمع بشكل فردي خاص، وهذا أدى بالتبعية إلى تقليل وإضعاف أثر (التكاتف الاجتماعي) من جهة، كما قوى من النزعة الأنانية في الفرد من جهة أخرى.
ويستشهد باومان على صحة ما ذهب إليه، عبر الاستناد إلى عدد من التقارير والإحصائيات التي أظهرت أن المتع الرئيسية في قائمة البريطانيين على سبيل المثال، هي متع فردية (استهلاكية) في المقام الأول، وتليها بعد ذلك اهتمامات (جماعية) بخصوص السياسة والحكم. أما في أميركا، فقد ظهرت النزعة الفردية في عدد من الإحصائيات التي قام بها موظفو الموارد البشرية، والتي أثبتت أن القائمين على التوظيف في الشركات يفضّلون تعيين (الأفراد) الذين هم من غير المرتبطين، بحيث يكون من الأسهل طردهم عند الاستغناء عن خدماتهم.
ويتطرق باومان في حديثه بعد ذلك، إلى مسألة سلطة الدولة في وضع (حالة الاستثناء)، وكيف أن تلك السلطة قد سمحت لها بإطلاق يدها في الكثير من الأحيان للقيام بحملات (إبادة جماعية) في أماكن مختلفة من العالم.
ويؤكد باومان على أن أكثر ما تختلف به الإبادة الجماعية عن أكثر الصراعات عنفاً ووحشية، لا يكمن في أعداد الضحايا، وإنما في (طبيعتها الفردية)، ذلك أنه في حالة الإبادة الجماعية تكون (الأهداف المتوقعة للعنف محددة من طرف واحد ومحرومة من حق الرد).
ويرى باومان أن من أهم الدروس التي تمخضت عنها حروب الإبادة الجماعية، ذلك الدرس الذي يعلن عن مبدأ (السيادة للأقوى)، فقد تم العمل على الشرعنة والتأكيد على ذلك المبدأ، وتم ذلك من خلال تجريده من كل الإيحاءات الأخلاقية المتعلقة به، فقد أصبح المهم هو الهيمنة والسيطرة للوصول إلى القمة والبقاء عليها، فصارت تلك الأهداف تمثّل قيماً مهمة في حد ذاتها، واستغنت عن أي قيم أخلاقية أخرى.
حياة عجولة: كيف فرض النمط الاستهلاكي نفسه؟
يقتبس باومان فقرة من أحد مجلات الأزياء الشهيرة، جاء بها (ستة مظاهر أساسية للأشهر الستة المقبلة، من شأنها أن تبقيك مواكباً للموضة).
يرى الكاتب أن ذلك العنوان مواكب بشدة لطبيعة وبنية المجتمع الاستهلاكي في عصر ما بعد الحداثة.
ف(الموضة) بمدلولها الذي يُشير إلى التقاليد التي يتبعها الآخرون (المشهورون والناجحون) بمقاييس المجتمع، تجعل منها تقاليد مرجعية فاصلة ما بين النجاح والفشل، إلى الحد الذي يحدو الجميع لمسايرتها والتوافق معها.
كما أن (الحرص على اتباع الموضة)، يُمثل الحاجة إلى تحقيق الاحترام بشكل مستمر ودائم من جانب باقي أفراد المجتمع، أو كما يعرّف باومان (اليقين بكونك ما زلت على الطريق الصحيح)، بما يحمله ذلك من معنى الاندماج مع الآخرين وتجنّب الوحدة والعزلة.
أما تحديد الفترة بـ(ستة أشهر فقط)، فهو يتوافق مع الشكل الاستهلاكي العنيف الذي يعد بالأمان لفترة محدودة فقط، مما يستلزم معه السعي بشكل متواصل ومستمر لتجديد ذلك الإحساس بالأمان.
أما بالنسبة لوجود (ستة خيارات مناسبة للموضة)، فهو تذكير للمستهلك بكونه حراً في عملية الاختيار، وفي نفس الوقت تنبيهاً له بأن عبء ومسؤولية الاختيار تقع بالكامل على عاتقه وحده، ونلاحظ أن الخيار هنا إلزامي ومحدود في نطاق معيّن مفروض مسبقاً، ولا يسع المستهلك أن يختار من خارجه.
وتتوافق الرؤية الكلية لكل ما سبق، مع المرتكز والمبدأ الأساسي للنظام الاستهلاكي، ذلك المبدأ الذي يتلخص في عبارة (إشترِ، استعمل، إرمِ)، حيث تظهر أهمية تحديد صلاحية كل (موضة/منتج) بوقت معيّن. فمن الضروري أن تنتهي صلاحية كل منتج في فترة زمنية محددة، حتى تتاح الفرصة لمنتج آخر ليحل بديلاً له. ولهذا فإن (النسيان) يعتبر واحداً من أهم عناصر اللعبة الاستهلاكية، فكما يقول باومان (الحياة الاستهلاكية هي حياة من التعلّم والنسيان السريعين).
فإذا كان المبدأ الأخلاقي للنشاط الإنتاجي –بحسب ماكس فيبر- هو (تأجيل الإشباع)، فإن المبدأ الأخلاقي للحياة الاستهلاكية –إن تجاوزنا واعتبرنا أن فيها مبادئ أخلاقية- سيكون (وهمية الشعور بالإشباع).
ومن هنا، فإن شعار تلك المرحلة سيكون (أن يكون العميل راضياً)، وفي نفس الوقت أن تتولد (حاجات زائفة) متجددة، بحيث يشعر العميل بالحاجة إلى تلبيتها وإرضائها وإشباعها.
ويتحقق ذلك عن طريق وسيلتين مهمتين، الأولى هي ازدراء الحاجات القديمة / الموضة القديمة، واعتبارها من الماضي المشين، أما الوسيلة الثانية فهي تجنّب وإقصاء هؤلاء الزبائن الذين لا يسعون إلا لأقل القليل من الحاجات.
من الممكن الوصول إلى تلك الأهداف، عبر الدولة أو المجتمع بسُبل مختلفة ومتنوعة، منها (التلقين الجمعي الأيديولوجي/الفكري) وكان ذلك يتم في مرحلة الحداثة الصلبة. أما فيما بعد ذلك، فقد تم الوصول إلى تلك الأهداف عبر عدد من الأنماط السلوكية المعقدة التي تم التدريب عليها، تلك الأنماط التي تدعو (إلى تقديم المصلحة الجماعية فوق المصلحة الفردية، بالإضافة إلى تقديم الآثار البعيدة المدى على الاشباعات الفورية).
السلطة والثقافة: من الصراع إلى التوافق
يناقش باومان التغيّرات الطارئة على بعض المصطلحات والتعريفات الدلالية المرتبطة بها، مثل مصطلح (الثقافة) على سبيل المثال.
فهو يؤكد أن ذلك المصطلح قد نشأ باعتباره (مصطلحاً وصفياً واسماً شاملاً لنظم السلوك البشري)، ويؤكد أن هناك مصطلحاً أسبق في الظهور من مصطلح الثقافة، ألا وهو مصطلح (الإدارة) الذي يعني (التحكّم بسير الأحداث) وهو ما يستلزم بالتبعية ضرورة (تقييد حرية الخاضعين).
وهنا تظهر إشكالية المعارضة والتضاد الجدلي الديالكتيكي ما بين (الثقافة العميقة) من جهة، و(الإدارة الحازمة) من جهة أخرى.
فكل أشكال الثقافة وتجلّياتها مثل (الفنون) على سبيل المثال، تُشكّل عبئاً على كاهل نُظم الإدارة، ذلك أن الروح الإدارية تحارب الصدفة، والتي هي الموطن الطبيعي الذي تنمو فيه الفنون. كما أن تلك الفنون تعمل في التخطيط لصنع بدائل متخيّلة للأوضاع الراهنة القائمة، مما يؤدي إلى حتمية حدوث تنافس مع الحكام والمديرين الذين تكمن سطوتهم في إقرار الأنظمة التقليدية.
وهنا يُبرز باومان تعارض الثقافة مع النمط الاستهلاكي، ذلك أن (الاستخدام أو الاستهلاك السريع، ليس غاية المنتجات الثقافية ولا معيار تقييمها)، ولهذا فإن فيلسوفة سياسية كبيرة مثل حنة أرندت قد أكدت مراراً على (أن الثقافة تأتي بعد الجمال)، وهي تستخدم لفظ (الجمال) هنا، للإشارة إلى الكثير من القيم والمبادئ الأخلاقية والروحانية، تلك التي لا يمكن أن تُقيّم بمعايير النمط الاستهلاكي المادي.
ويبيّن باومان أن المفهوم الكلاسيكي للثقافة في المرحلة الصلبة للحداثة، كان يتسق ويتكامل مع (الأفق النموذجي لشمولية اجتماعية موجّهة جيداً)، فقد راعى الشموليون أن تكون الثقافة السائدة في مجتمعاتهم متسقة مع نظم الإدارة الشمولية السائدة، وهو ما تم التعبير عنه بعبارة (مجتمع واحد= ثقافة واحدة).
أما في عصر الحداثة السائلة، فقد تراجع الشموليون عن ممارسة أدوارهم التقليدية التي اعتادوا عليها فيما قبل، فنجدهم قد تقمصوا قميص (الوكالة) وواصلوا لعب دور (الوسيط النزيه) الذي يعرض حاجات وسلع السوق الاستهلاكي من دون أن يجبر الزبائن على شرائها بالقوة أو الجبر. من هنا، فإن باومان يؤكد على أن الصراع الأبدي ما بين السلطة والثقافة قد فقد شكله الاعتيادي، كما إن محاولة إخضاع المجتمع لقيم ثقافية محددة أصبحت غير مجدية ولا طائل من وراء السعي لتحقيقها. ولهذا نجد أن الأمور الثقافية قد سُحبت (وطُرحت للبيع أمام المتبضعين الأفراد في أشكال محدثة من مخازن الجيش والبحرية للفائض).
وهذا أدى بطبيعة الحال إلى إخضاع (الإبداع الثقافي) لمعايير السوق الاستهلاكية ومقاييسها، وهو ما يعني أن تلك القيم الإبداعية قد صارت تُقيّم بالقيمة السوقية الاستهلاكية فحسب، (فالعملاء المرتقبون وأعدادهم وحجم المال في حساباتهم البنكية هو الذي يقرر حالياً (بجهل) مصير الإبداعات الفنية، وتَرسم المبيعات والتقديرات وعائدات شباك التذاكر الخط الفاصل بين المنتجات الناجحة وبين المنتجات الفاشلة).
محمد يسري أبو هدور باحث مصري متخصص في التاريخ الإسلامي والحركات السياسية والدينية.
المصدر: الميادين نت






