قراءة مركّبة في رواية “919 هجريّة”
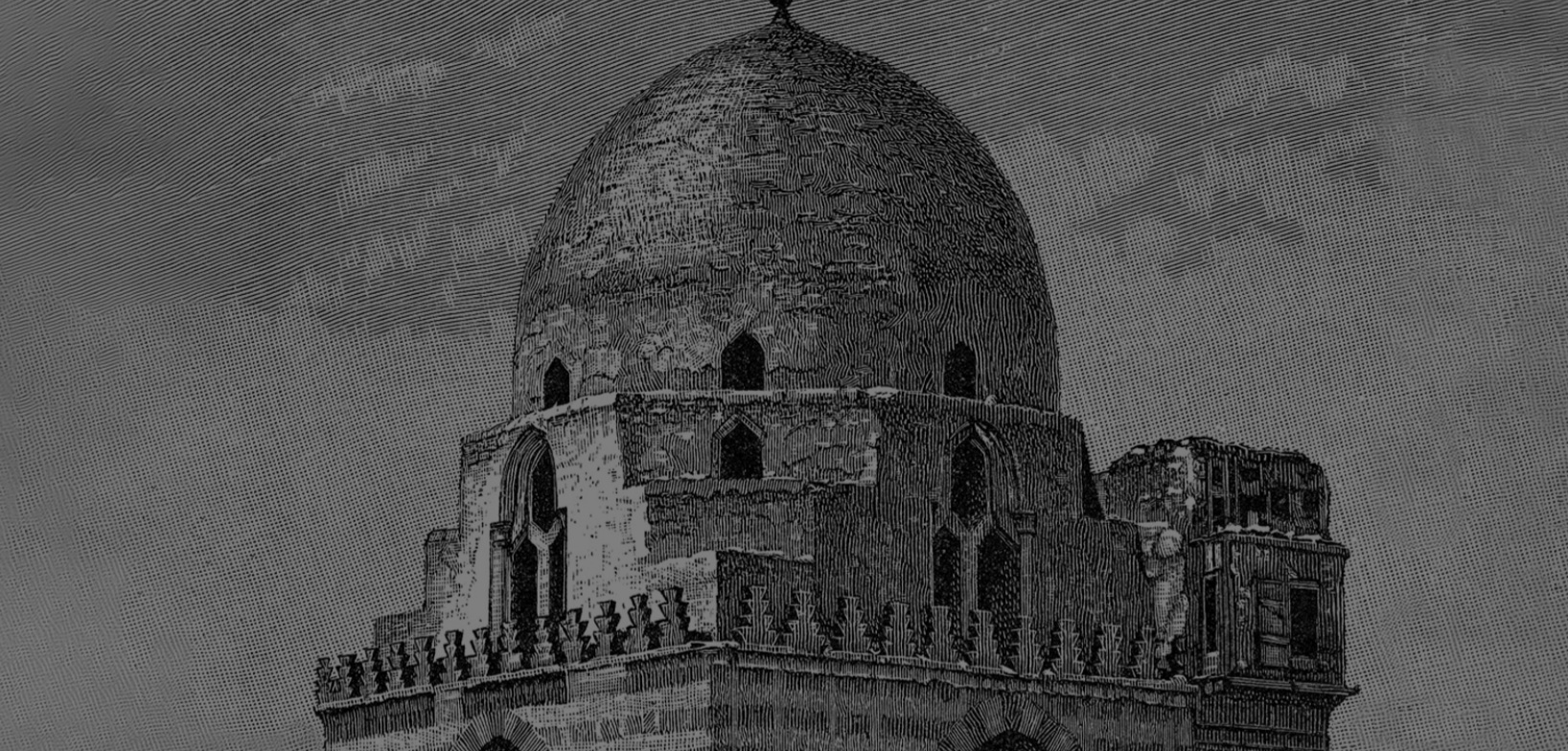
شجون عربية _ بقلم: د. سوسن ناجي _
كاتبة وناقدة من مصر/
تُقدِّم رواية “919 هجريّة” للروائيّ المصريّ إبراهيم صالِح نَمطاً من الكتابة السرديّة المُختلفة في تجربتنا الأدبيّة المُعاصرة، حيث تبدو بما تنطوي عليه من إشارات أدبيّة خروجاً صريحاً على الكتابة السرديّة التقليديّة في نَهجها وبنائها، ربّما لانتفاء مركزيّة المكان، بل وانكسار الزّمن إلى وحدات سرديّة، فضلاً عن الرؤية الذاتيّة للسارد، التي أَنتجت خطاباً استهدفَ القبض على القارئ بإيقاعه في شِباك البناء الدائريّ المُعتمِد على تكسير الزّمن لتقديم قراءة جديدة للواقع المصريّ عبر التاريخ، وبالتحديد في حقبة عصر المَماليك، وما انطوى عليه هذا العصر من سقطة حضاريّة للمصريّين، أو كبوة اجتماعيّة وسياسيّة أفضت بهم إلى الإحساس بالغربة داخل الوطن.
يقول الراوي: “تتوالى عجلة الزَّمن.. كانت المِحن والقلاقل تتفجر… كلّ القاهرة تملَّكها الفزع من المَماليك، يجوبون الطرقات بخيولهم وهُم مُمتلئون بالرعونة والتعالي… ينهبون الدكاكين، ويجرون بخَيلهم دائسين المارّة”. ولذا كانت رحلة الخروج من المحروسة هي المنطلق الوجودي الذي يروم المؤلِّف من خلاله الكشْف عن التحوّلات التي طرأت على المُجتمع المصري، أو هي محاولة لإيجاد التبرير للانهيار الذي طرأ على نَسق حياة المُجتمع المصري، بما تنطوي عليه من عادات وتقاليد وثقافة واقتصاد.
في رواية “919 هجريّة” يتمّ تكسير الزَّمن وإذابَة الفواصل بين المُدن والحقَب التاريخيّة من أجل إدماجها معاً، واستحضار نصٍّ تاريخي يتوالد ويَسير في اتّجاه مَناطق وعوالِم مجهولة، مَبنيَّة على نسقٍ بلّوري متعدّد الزوايا. وفيه تتجاوَر المَشاهد المُتباينة الحدوث، وتتجاوَر الأحداث التاريخيّة في عشوائيّة غير نمطيّة، وكذلك تتجاور الأماكن الأثريّة في إطارٍ من الدهشة والتوثيق، سواءً أكانت هذه المَشاهد في القاهرة أم في المنيا، وتتردَّد الأسماء نفسها، وتتكرَّر مزاياها التاريخيّة مثل: باب زويلة، الخانكة، بولاق، خان الخليلي، شبرا، قناطر السباع… ثمّ تأتي بينها مَشاهد للأحياء أو القاطنين في تللك الأحياء. وتتوالى تلك المَشاهد في جدليّة ومن دون انتظام، الأمر الذي يجعل النصّ يبدو من الجهات كافّة، ومن الزوايا الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة المُختلفة. وتصبّ جماليّات هذه التقنيّة في السرد في مصلحة المُتلقّي الذي يبقى في شغف وانتظار لكونه يستطيع تصفُّح هذا العالَم الروائي من أيّ مَشهد في الرواية ثمّ ينطلق بالحدث نحو النهاية. وبفضل دائريّة الأحداث والبناء تتوحَّد البدايات مع النهايات، لتبدو نهاية الرواية هي البداية ذاتها التي انطلقت منها.
يأتي عنوان الرواية “919 هجريّة” بمثابة عتبة سيميائيّة للإشارة إلى أهميّة حقبة تاريخيّة معيّنة في عُمر الزمان، وقيمة إعادة النّظر فيها لإدراك الحاضر ووضْع اليد على أسرار الركود في الوعي وفهْم أسباب الانهيار، وعدم القدرة على الإتيان بحضارة توازي حضارة العبّاسيّين.
ظلّت الدولة المملوكيّة كعلامة فارقة في حياة المصريّين، ونقطة تحوّل في حياتهم. من عِزّة إلى شقاء، ومن غنىً إلى فقر وعَناء، ومن حضارة إلى همجيّة وغوغاء،. فقد استُبيحت أعراض المصريّين، وانهارت مُقدّراتهم، وانزوت ثقافتهم، وحلّت الغربة داخل الوطن، وتحوَّلت سكينتهم إلى فرار وحركة.
يصف الراوي ما حلّ بالمصريّين وأوضاع المَماليك في تلك الحقبة قائلاً: “المَماليك ودولتهم مُرتزَقة، يُجلَبون من كلّ الأصقاع، ولا همّ لهم سوى عصْر المصريّين واستخراج الأموال منهم، جلبوا الخراب والنّحس للبلاد، أذاقوا العباد الذلّ والهوان، وألحقوا بهم الفقر ونشروا الفساد والرشوة، صاروا أداةَ هدم ومعول تخريب، عساكرهم أيضاً لا تخرج للحرب إلّا إذا أَنفق السلطان عليهم”.
يُحاكي الروائي هنا التقنيّات السينمائيّة، كالتزامُن في الجمْع بين زمانَين، أو مكانَين في مَشهد واحد، وهو ما يُعرف بالمونتاج المُتوازي؛ حيث تتقاسم الصور وتَجتمع في كادر واحد، وهو ما يُعرف بسينما اللّقطة، وهذا أسلوب يعتمده الكاتب في مزْجه بين مَشاهد الرواية. بل وتُقسَّم الرواية إلى تسعةٍ وستّين مَشهداً، تنضوي في إطار أجزاءٍ خمسة، عبَّرت عناوينها عن مَفاصل الأحداث وسيرورتها، التي تمضي في طريقٍ دائريّ من خلال تقنيّة الاسترجاع (Flashback) كالآتي: الجزء الأوّل: الخروج؛ الجزء الثاني: رحلة الوصايا؛ الجزء الثالث: منزلق حادّ؛ الجزء الرّابع: التجربة؛ الجزء الخامس: التحوّل.
ولا يُقدِّم الروائي في روايته سياقاً متّصلاً، بل هي لقطات مُتجاوِرة، في صورة مَشاهد قصيرة، ترصد لنا أمكنة متعدّدة عبر فترة زمنيّة بعَينها (عصر المَماليك)، ولكنّها تُقدَّم من خلال لوحات مكانيّة موغلة في قلب القطر المصري، وبالتحديد في برّ سمالوط أو أقاليم شمال الصعيد. والروائي هنا يؤسِّس للحظةٍ جديدة – تاريخيّة – تذهب بالنصّ الروائي إلى فضاءات الماضي (العصر المَملوكي) البعيد من المكان والزمان بهدف خلخلة ثوابت القديم الراكد داخل الذات المصريّة إلى درجة الرسوخ، ولاسيّما في ما يتّصل بالعادات والتقاليد المصريّة العتيقة، والتي تُجرِّم خطيئة المرأة، بينما لا يأثم الرجل، وبخاصّة إذا كان مملوكيّاً. ونَجِد السلطان ذاته يتعنَّت ليُقيم الحدّ على “حسناء” وعلى “علي المشالي”، ويُصدر عليهما حكماً كالتالي “يُشنقان في حبْلٍ واحد، ويجعل وجه الرجل مقابل لوجه المرأة” في قسوة مُبالَغ فيها، متحدّياً في ذلك مشورة أهل القضاء وأهل الشرع معاً.
إنّ تحطيم البناء السببي في الرواية، واستبداله بمنطق اللّاوعي المُتشابك المُعقّد، المُنفلت من العلاقات الوصفيّة إلى العلاقات الديناميكيّة الانزياحيّة، والتي تبدو وكأنّها اجتياحٌ للذاكرة والتاريخ والأزمنة والأمكنة، يجعل من مثل هذا النَّوع من الكتابة وكأنّه فوضى مجازيّة، موظَّفة لتوصيل رؤية ذات طبيعة مجازيّة، لتكون في النهاية بمثابة مرآة تعكس فوضى القيَم التي طرأت على المُجتمع… أضف إلى العبثيّة التي أخذت تَسِم هذا الواقع.
وانعكست العبثيّة والفوضى أيضاً على البناء السردي الروائي كمرآة تعكس صورة الحياة الاجتماعيّة في عبثيّتها وتناقضها! ويظلّ كابوس الحُكم المملوكي يُلقي بظلاله على الوجدان الشعبي الذي فقد الانتماء والقدرة على التغيير. وظَهَرَ هذا جليّاً في بناء الشخصيّة لكلٍّ من “عبد الرّحمن”.. و”أثناسيوس”.. حتّى ماريان… جميعهم فقدوا الانتماء إلى المكان مع حضور الرغبة في السفر والترحال وما ينطوي عليه السفر رمزيّاً من دلالات الرغبة في التغيير مع العجز. وكانت الرحلة في الزمان والمكان هي العنوان الحقيقي لرغبات الخروج الملحَّة، والتي انتابت كلّ أبطال الرواية. حتّى “ماريان” كانت رغبتها في الخروج متمثّلة في الدير، وما ينطوي عليه الدير من قيودٍ منظِّمة للذات والشهوة والآخرين.
استراتيجيّات التشتُّت
ومثل هذه الرؤية تعتمد استراتيجيّات التشتُّت وعدم الانتظام، والهدف هو تأسيس مفاهيم بديلة في المجتمع تنهض من مَلَكَة نقْد الذات. ومن خلخلة المفاهيم الكائنة، أو السائدة في المُجتمع، لإنتاج الاستقرار والتوازن.
إنّ التحوّل الذي طرأ على كلّ الشخصيّات في هذه الرواية، (في الجزء الخامس: التحوّل)، لم يأت بجديد إلّا بعد التجربة. ففي الجزء الرّابع كان التغيير والتحوُّل في الشخصيّة نِتاجاً حقيقيّاً للحركة والتجربة. تقول “ماريان” (بعد تحوُّل تجربتها وحضور الرغبة في مُغادَرة الدير): “لا أرغب في وصاية البشر. أخوض التجربة بنفسي. أجعل روحي حرّة وطليقة. وتُحدِّد ماذا تريد، لم اسمح لأحد أن يوجِّهني. أنشد الحريّة المُطلَقة. كلّ شيء اختياري وبإرادتي. أدخل التجربة بمشيئة خالِصة، الزهد، التقشُّف، نبْذ كلّ شهوات ورغبات الدنيا، العزلة أيضاً تجربة ذاتيّة”.
ويحكي الراوي عن تجربة “عبد الرّحمن” وسفره إلى الصعيد (المنيا – برّ سمالوط) ويقول: “الجَلْد الذاتيّ للنَّفس يشفيه، الشعور المُستمرّ بالذنب، وتأنيب الضمير… صارت نفسه اللّوّامَة تحتقر الرغبات التي تدفعه لارتكاب الآثام والموبقات. خرج من المحروسة هَرَبَاً. تتسلَّط الرغبات والشهوات عليه.. وتتحكَّم في كلّ تصرّفاته. حينما خرجَ واستقلَّ الفَلَك كان في حاجة لأن يخلع ذلك الثوب الذي كانت شخصيّته تعيش بداخله. ساعده الخروج. صَفَتْ روحه، وهدأتْ نفسه. وشحَّت وجبات الأكل للغاية وتباعدت فترات تناولها. تلاشت منه الرغبات والشهوات التي كانت تُسيطِر عليه”.
وتأتي اللّغة عبر هذه العوالِم لتكون هي المُحرِّك الأوّل لصانع الحكاية – إجمالاً- حيث كانت هي المحرِّض الأوّل لنقْل الحَدَث (غير المُنتظِم) من البنية الدراميّة التي تميّزت بإنتاج خطاب الواقع إلى بنية التحوُّل التي اعتمدت خطاب الماضي. وعبر هذه المُفارَقة يتمّ تأويل الواقع أو إنتاجه أو إدراكه لكونه مَبنيّاً على أطروحات الماضي، وسقْطة المَماليك ودهْس الشعب.
كما تنساب نزعه دينيّة (الزهد) لتتدفَّق أو لتَظهَر في نسيج الحكي وأفعال الشخصيّات الرئيسة التي خرجت لتبحث عن معنى للحياة أو لفهْم المغزى من قصديّة الحركة في المكان. يقول أثناسيوس: “لديّ الرغبة في الخروج إلى البريّة مثل أولئك النسّاك الذين يعتزلون صخب الحياة. وما الجدوى؟ رغبة تتملّكني وتستحوذ عليّ بشدة – ألا من سبيل لتعيش حياة الزهد والتقشُّف بدون الخروج للخلاء؟ أريد أن أخوض التجربة كاملة، الزهد والتقشُّف والعزلة أيضاً وطريق الخروج واضحة مَعالِمه من أمامي وقرَّ عليه عزمي”.
هكذا، وباختيار الماضي (عصر المَماليك) تاريخاً كإطارٍ تاريخي، “يكون المؤلِّف قد تحرَّر وجوديّاً إلى حدّ غير قليل من وطأة الإكراهات الأيديولوجيّة العاملة تحت إمرة الوعي، والمُرتبِطة بطبيعة المرحلة الحاضرة التي يعيشها المؤلِّف كقضيّة تعكس التناقض القائم في الواقع. وفي الوقت ذاته يعكس إشكاليّة القائم في الواقع، ويُعادله فنيّاً” (سوسن ناجي، خوف الكتابة، القاهرة، 2013).
يبقى أنّ جماليّة هذه النوعيّة من النصوص تبدو في مُحاولتها مخاطبة القارئ “الذي تتغيّر ثقافته وظروف حياته وأنواع نشاطاته، ويتحوّل مزاجُه بتباين أشكال الترفيه والتسلية وتجدُّدها المُستمرّ، وتتبدّل اهتماماته واحتياجاته الماديّة والتاريخيّة. ومع ذلك تظلّ هذه النصوص التي تتعمّد مُفارَقة الواقع… والارتحال إلى مناطق مجهولة لم تعرفها الخبرة الإنسانيّة، قادرةً على مُخاطَبة هذا القارئ المُتغيِّر” (صبري حافظ، جدليّات البنية السرديّة المُركَّبة، مجلّة فصول، المجلّد 3، العدد 2، صيف 1992).






