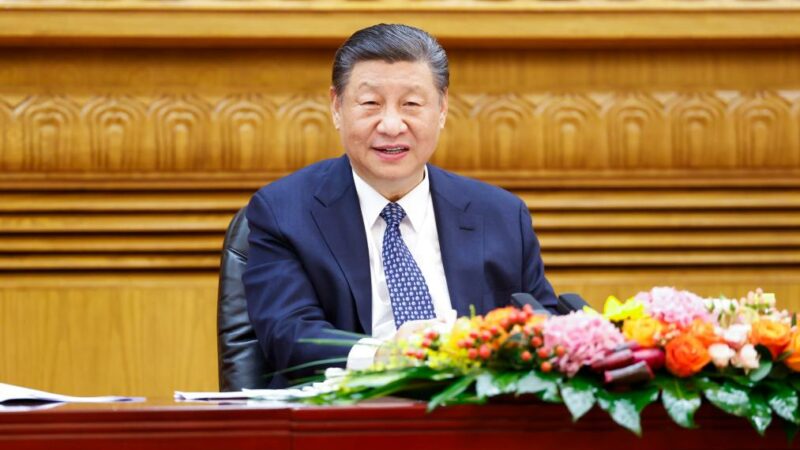السودانيّون يواجهون “أقدار التاريخ”

يبدو التفكير في مستقبل دولة كالسودان، محمَّلاً بالكثير من المُفارقات، بين الإمكانيّات على الأرض والمَوارِد الطبيعيّة والبشريّة والمَواهِب وغيرها من العناصر الإيجابيّة الدّاعمة لحراك النهضة في اتّجاه اقتناص الحياة الأفضل.
في مقابل ذلك ليس من أُفقٍ إيجابي لتحوّلٍ سياسيّ عميق يعمل على خلخلة أنظمة الحياة التقليديّة وينقل الإنسان السودانيّ إلى استشراف الآمال، الحلم/ القديم، ببناء جمهوريّة الحريّة والسلام والعدالة، الشعار الثلاثي الذي رفعه ثوّار السودان في ثورة كانون الأوّل (ديسمبر) التي اقتلعت نظام البشير، حتّى ولو أنّ المَشهد إلى الآن يبدو كما لو أنّه مجرّد اقتلاع لرأس النّظام، كما عبَّر عن ذلك بدقّة البيان الأوّل للانقلابيّين في الحادي عشر من نيسان (أبريل).
لقد فوجئ السودانيّون بعد قرابة خمسة أشهر من الاحتجاجات والاعتقالات والموت أنّ الطريق الذي كانوا يحلمون به، لم يأتِ بالتوقّعات المرجوَّة، كأنّما أعيد تركيب أو تشكيل الصورة القديمة نفسها في إطارٍ جديد، وطغا العسكريّون على كلّ شيء، باعتبارهم “شركاء” في التغيير، وهي اللّغة التي استخدموها لتبرير مَواقفهم وحاجتهم لأن يكونوا في صلب الحكومة الانتقاليّة وسلطة صناعة القرار، وأضافوا إليها لغة القتل والتخويف، يمدّون العصا تارة والجزرة تارة أخرى؛ إذ لم يكُن سهلاً بالنسبة إليهم الرجوع إلى ثكناتهم كما جرى التعبير، وظلَّ نائب رئيس المجلس العسكري يردِّد بلغة دارجة وبسيطة مأخوذة من سياق خبرته الحياتيّة ” كيف نرجع.. نحن شركاء في هذا التغيير”.
عندما اعتلى البشير السلطة في انقلابٍ عسكريّ في حزيران (يونيو) 1989 وبعدها بسنوات وجيزة، أَطلق الكاتِب السوداني الرّاحل الطيّب صالح مقولة شهيرة “من أين جاء هؤلاء؟”، التي فُهمت في إطار التساؤل، في حين لم يوضح – هو – مَقصده مباشرةً؛ بيد أنّها في الواقع عبارة تحتمل التعجّب! أكثر من الاستفهام؟؛ فالانقلابيّون الجُدد وقتها من زمرة الإسلامويّين وتحالُف القوى الرجعيّة، كانوا قد جاءوا من صلب المجتمع السوداني، فهُم لم يهبطوا من السماء، وهنا المُفارَقة التي لا يُمكن لأغلب السودانيّين الرضا بها، لأنّ مواجَهة الواقع صعبة لدى أغلب الناس. فالعادة أنّ الجماهير تبحث عن الصور الذهنيّة الإيجابيّة عن نفسها، وأنّها دائماً على ما يرام، ولا ترغب في ضرب الرأس بصخرة الواقع لتحصيل الألم فالشفاء.
الآن يتجدّد المَشهد بطريقة أكثر دراميّة، ويُمكن طرْح السؤال أو الاستفهام مجدَّداً، لنَجد كيف عمل المجلس العسكري الانتقالي على عددٍ من الخطوط الدّاعمة لاستمراره عبر توظيف القوى الأهليّة، أو العشائر، ما يُعيد تجربة الاستعمار الإنكليزي في هذا المسار، وكيف انتهى الوضع بعد استقلال البلاد في العام 1956 إلى قيام حزبَين طائفيَّين، يؤكّدان على أنّ مشروع الحداثة والتمدّن وقيام التعليم الحديث، ليسا إلّا إطاراً شكلانيّاً استطاع في نهايته أن يفضي إلى استيعاب، بل إغواء “الأفنديّة”. ووسط هذا التصوُّر، برزَ تيّاران هُما الإسلاميّون في مقابل الشيوعيّين واليساريّين، وكلاهما كان يعبِّر عن أشواق بعيدة الأهداف، ما بين الدعوة إلى قيام دولة الشريعة وفي الطرف الثاني الدولة الاشتراكيّة الحالِمة، وكلاهما مارسَ التطرُّف والاستقواء. فالنميري جاء في العام 1969 بالتخطيط اليساري قبل أن ينقلب عليهم ويهرع في اتّجاه اليمين، والبشير جاء، كما هو معروف، عبر صهوة الجواد الإسلاموي.
التيّاران المُتباعدان، وإلى اليوم، يتقاسمان الذهنيّة العامّة في تفسير الأمور وفرْزها في المجتمع السوداني، فإمّا أنتَ يميني بحت “كوز” وفق التصنيف السوداني، وهي عبارة دارجة تشير إلى “الاعتراف” وتعني المنتمي إلى جماعة الترابي، ومن ثمّ أنتَ شيوعي وكافر.
لم يتحرّر الذهن بعيداً كي يقود الجماهير إلى اقتراحات مُثيرة ومستقبليّة في إعادة فرْز الوعي الجمْعي وبناء أنسقة جديدة للحياة الإنسانيّة، بعيداً من مركّبات الثنائيّة والتاريخ اللّولبي الذي لم ينطلق بعيداً عن تراكمات ما يقارب خمسة قرون منذ تأسيس ما يُعرف بتحالُف دولة الفونج أو سنار، مطلع القرن السادس عشر الميلادي، تلك الحقبة التي تُشكّل إلى اليوم المخيال الجمْعي السوداني، وحركة السياسة والأدلجة الاجتماعيّة وتصوّرات الغيب والواقع.
هذه التقديمات تشير إلى أنّ مشكلة السياسة في السودان مُرتبطة في جوهرها بالأنساق الاجتماعيّة وبالطبيعة العشائريّة للمجتمع والبناء الغَيبيّ للذهن، ومن يَرجع إلى كِتاب “الطبقات” لمؤلّفه ود ضيف الله الذي يصوّر تاريخ الأولياء والمتصوّفة في حقبة سنار، سوف يعرف أنّ ما حكى عنه الرجل من قدرات خارقة لهؤلاء الناس وكرامات غريبة، وغيرها، ما زال موجوداً بشكلٍ أو بآخر في تصديق العوام، في مقابل أنّ السلطة متمثّلة في السلطان من جهة وزعماء الطُّرق الصوفيّة والمَشايخ من جهة ثانية، هي التي تتصارع وتُوازِن الأمور، وهي التي توزِّع الأرض الزراعيّة بطريقة لم يتمّ تحييدها بشكلٍ حقيقي إلى اليوم.
يُمكن للاستكشاف الحقيقي لتاريخ السودان أن يوضِّح الصورة المجهولة حتّى لبعض السودانيّين أنفسهم من الجماهير التي لم تؤسِّس مَعرفة فلسفيّة للتاريخ، دعك من النخبة السياسيّة التي بذلت محاولات في إطار الوعي التحديثي ليصل أغلبها إلى طريقٍ مسدود في ظلّ مُقاوَمة النسق القديم. وفي حين استسلم البعض، فإنّ هناك مَن عمل بوعيٍ تامّ وإدراك على الاستفادة من مقوّمات البناء الاجتماعي في التسيُّد السياسي، كما في أنموذج حسن الترابي الذي نسجَ مشروعه بالاعتماد على الإغواء الديني والعزف على هذا الوتر الحسّاس داخل المجتمع السوداني، ولعب على ما يحمله الفكر الغَيبيّ من ترسّبٍ عميق في طبقات العقل.
قبل أكثر من مائة عام في الفترة من العام 1881 إلى العام 1885، استطاع محمّد أحمد المهدي، وهو لقب أطلقه على نفسه، تثوير السودانيّين ضدّ الحُكم التركي العثماني والخديويّة، واستطاع أن ينجح في ثورته بإنهاء حقبة الأتراك التي امتدّت منذ العام 1821؛ لكنّ ذلك لم يتمّ لولا الاستناد إلى دعامة المهديّة، الادّعاء الكامل بأنّ الحقيقة التي تقوده مستلَّة من التلقّي المباشر الذي تمليه الغيبيّات عليه، واستفاد محمّد أحمد من الخرافة والميتافيزيقيا ليصل إلى هدفه، بغضّ النظر هل كان يعي حقيقته كمَهْدٍ مُزيَّف أو يندمج داخل هذا النسق الذي كان سمة ذلك العصر، مع التكلّم على نهاية مرحلة من التاريخ على رأس قرنٍ هجريّ جديد مُقبِل، ليكون التجديد للدّين والرسالة وفق ما جاء في الميراث الديني والنبوي المُتعارَف لعامّة الناس. وسنجد هذا المَلمَح نفسه بشكلٍ آخر، عند المفكّر اللّاهوتي محمود محمّد طه الملقَّب بـ”الأستاذ” الذي يُعدّ مفكّراً حداثويّاً في المسألة الدينيّة، غير أنّ التحليل العميق لتجربته يكشف جذور الثقافة السودانيّة والبُعد الصوفي والعرفاني في عُمق ما يذهب إليه من تصوّرات، وهو يدعو إلى مشروع “الرسالة الثانية من الإسلام” ويمزج بين العمل السياسي والدعوة والرغبة في التثوير الاجتماعي.
الآن ثمّة ما يُعرَف بالجيل الوسيط، الذي صنعَ الثورة، ليعيش الاكتواء بمُفارَقات التاريخ وتراكُمات الوعي الجمْعي، حيث لم يتحرّر منها بالمعنى الشافي، بل يقف في مساحة التيه ما بين التوقّع غير المُعرَّف وحقيقة يبحث عنها في شكل هويّة أو التزامٍ قومي قد يجده في ثنايا التاريخ، وهي غير حاضرة بسبب ضعف التأسيس الفلسفي لمعرفة التاريخ وغياب الفكر القومي المؤسِّس له، في ظلّ العصبيّة والعرقيّة والحروب الأهليّة الطويلة، وأوضحها حرب الجنوب التي استمرّت خمسين سنة وأدَّت إلى استقلال نصف البلاد في العام 2011، وحرب دارفور في العشريّة الأولى من هذه الألفيّة، ووظّف في هذه الحروب فكر الثنائيّات البغيضة من عنصريّة عرقيّة ودينيّة، ما بين سوداني أبيض وآخر أسود، أو مسيحي ومسلم، أو عربي وأفريقي. الثنائيّة التي من المفترض أن توحّد السودان وصارت للأسف سبباً للتشرذم والتباغض.
الجيل الوسيط، يحمل مُقاربات العَولمة وصنعَ ثورته بناءً على لغة جديدة ومخيال اجتماعي جديد، مستفيداً من تجلّيات عصر “السوشيال ميديا”، لكنّه يفتقد إلى القدوة السياسيّة والقيادة الخلّاقة، يبحث عن متّكىء فكري وفلسفي يستند إليه، غير واضح وربّما غير موجود. ولا ننسى الإشارة هنا، إلى أنّ هناك ملايين السودانيّين يعيشون في دُول الاغتراب والمَهاجر، ويبقى الحديث عن مستقبل السودان مُرتبطاً إلى حدّ كبير، وقبل كلّ شيء، بتعزيز الثقة بفاعليّة الحياة في هذا البلد؛ إذ ليس من مشكلة في الكوادر المؤهَّلة أو العقول أو المواهِب، أو القدرة على التخطيط، لأنّ التحدّي الأساس يكمن في تحرير العقل الجمْعي من الماضي والتاريخ. إنّ ثورة كاملة وكبيرة مُمكِنة لتُكمِّل الطريق، وهذا يعني ببساطة عملاً دؤوباً وحفراً عميقاً مُناطاً بنخبة، هي مبعثرة في أغلب الأحيان، لم تنهض من شتات الفكر أو الإحساس بضرورة إنتاج واقعٍ مُغاير.
عماد البليك/ كاتب من السودان/
مؤسسة الفكر العربي