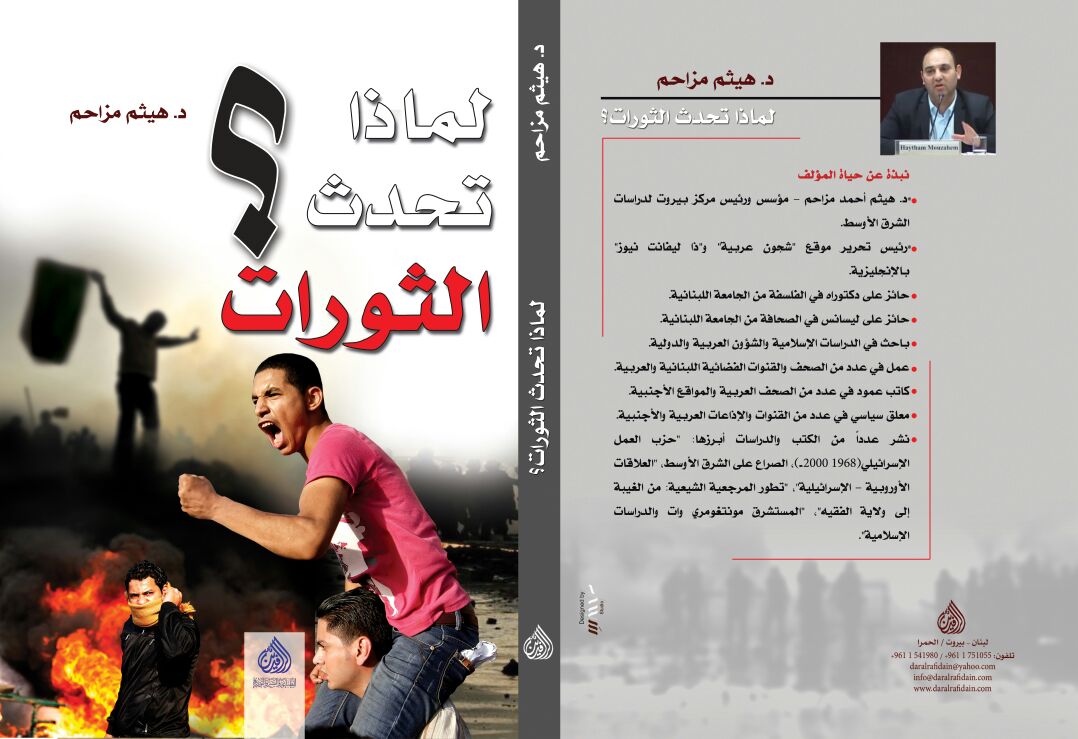من التقية والانتظار إلى ولاية الفقيه

د. هيثم مزاحم — شكّلت غيبة الإمام الثاني عشر عند المنظومة الشيعية الاثني عشرية، من دون تحديد موعد لظهوره كـ”مهدي للأمة” فراغاً عملياً في منصب المرجعية الدينية والقيادة السياسية. وبدأ علماء المذهب بالبحث عن آليات لسد هذا الفراغ للإجابة عن المسائل الفقهية والدينية المستجدة من جهة، وترشيد سلوك الشيعة السياسي والاجتماعي تجاه السلطة السياسية القائمة من جهة أخرى. وقد تطورت رؤية الفقهاء لمسؤولياتهم تدريجياً من قبولهم بأخذ الخُمس من الناس وتوزيعه على المستحقين، إلى إقامة الحدود وصلاة الجمعة. لكن نظرية النيابة العامة لم تتطور إلى نظرية سياسية تشمل جميع شؤون الحياة المعطلة في عصر الغيبة.
ترتب على اعتقاد الاثني عشرية بفكرة “التقية” والانتظار أن يرفض معظم فقهائهم التصدي للإمامة والقيام بتشكيل الدولة في عصر الغيبة، وذلك لأن الإمامة تشترط إماماً معصوماً ومنصوصاً عليه، بحسب اعتقادهم. ومع تطور علم أصول الفقه ونشوء مفهوم الاجتهاد والتقليد، نشأت نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام الغائب في إدارة الأمور الحسبية، التي تتضمن إدارة أموال الأوقاف والخُمس والزكاة وأموال السفهاء ومن لا ولي له وتكفّل اليتامى والمحتاجين، وهي من الأمور التي لا ينبغي تركها لضرورة حفظ النظام العام.
لكن قيام الدولة الصفوية، وما رافقه من نهوض اجتماعي وسياسي للشيعة في إيران، قد وفّر الظروف المناسبة لبحث مسألة الحكم والدولة في الفقه الاثني عشري. أما أول فقيه بحث بالتفصيل في مسألة ولاية الفقيه وجعل منها مسألة فقهية مستقلة، وأقام عليها الدليل العقلي والأدلة النقلية فهو الشيخ أحمد النراقي (ت 1248هـ)، فقيه العصر القاجاري، في كتابه “عوائد الأيام” حيث يشير إلى مسألة ولاية الفقيه للمرة الأولى بصورة يمكن اعتبارها جزءاً من الفكر السياسي. فقد رأى النراقي أن للفقيه ما للإمام المعصوم من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة، وهو تحوّل مهم في المذهب إذ منح الفقيه دور القيادة السياسية بعدما كان دوره مقتصراً على المرجعية الفقهية والدينية، أي السلطة الشرعية من دون السلطة السياسية الزمنية.
لكن اتجاه ولاية الفقيه لم يستطع أن يصبح اتجاهاً عاماً وعملياً عند الاثني عشرية، بل بقي اتجاهاً محدوداً ونظرياً، فيما ظهرت نظريات سياسية أخرى في موازاته هي نظرية “السلطنة المشروعة” التي تفصل بين الدين والدولة، حيث تمنح الفقيه السلطات الشرعية الدينية من قبيل الأمور الحسبية، من إدارة الأموال الشرعية والقضاء والفتيا في مقابل الاعتراف للسلطان المسلم ذي الشوكة بالسلطة السياسية أو الزمنية. كما ظهرت في أوائل القرن العشرين نظرية “الحكومة المشروطة” مع الشيخ محمد النائيني (ت 1355هـ)، التي واكبت ثورة الدستور في إيران عام 1905 ضد الشاه، وهي نظرية تدعو إلى تحديد سلطات السلطان السياسي المستبد وتقييدها بالدستور أو “المشروطة” ومشاركة بعض الفقهاء في مجلس الشورى (البرلمان) الذي يقوم بسنّ القوانين والتشريعات لضمان عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية ولمنع استبداد الحاكم المسلم.
بيد أن التحول الأبرز في الفقه السياسي الاثني عشري جاء مع الإمام الخميني (ت 1989)، عندما أعاد إحياء نظرية ولاية الفقيه العامة، وجعلها ولاية مطلقة واستطاع أن يأخذ بها إلى حيّز التطبيق العملي عبر إقامة “الجمهورية الإسلامية” في إيران عام 1979 بعد انتصار الثورة على الشاه محمد رضا بهلوي.
مهّد الخميني للقول بولاية الفقيه بضرورة الإمامة في عصر الغيبة، وقال: “إن ما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر (ع) لا سيّما مع هذه السنين المتمادية، ولعلّها تطول. والعياذ بالله، إلى آلاف السنين. والعلم عنده تعالى”. وقال: “أية حاجة كالحاجة إلى تعيين من يدبّر أمر الأمة ويحفظ نظام بلاد المسلمين طيلة الزمان ومدى الدهر في عصر الغيبة، مع بقاء أحكام الإسلام التي لا يمكن بسطها إلاّ بيد والي المسلمين وسائس الأمة والعباد”. واستشهد بقول السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد (ص) في خطبتها المعروفة و(الطاعة نظاماً للملّة والإمامة لمّاً من الفرقة) كدليل على لزوم بقاء الولاية والرئاسة العامة، وقال: “أمّا في زمان الغيبة فالولاية والحكومة، وإن لم تجعل لشخص خاص، لكن يجب، بحسب العقل والنقل، أن تبقيا بنحو آخر، لما تقدم من عدم إمكان إهمال ذلك، لأنها مما يحتاج إليه المجتمع الإسلامي”.
وقد رفض الخميني نظرية التقيّة والانتظار السلبية للإمام الغائب المسمّى محمد بن الحسن العسكري والملقب بـالمهدي رفضاً مطلقاً، واستدل بالأدلة العقلية على ضعف الأحاديث التي كانت توصي بهذه النظرية. وكتب يقول: “بديهي أنّ ضرورة تنفيذ الأحكام (الشرعية) لم تكن خاصة بعصر النبي (ص) بل الضرورة مستمرة، لأن الإسلام لا يحد بزمان أو مكان. لأنه خالد فيلزم تطبيقه وتنفيذه والتقيّد به إلى الأبد. وإذا كان حلال محمد حلالاً إلى يوم القيامة، وحرامه حراماً إلى يوم القيامة، فلا يجوز أن تعطّل حدوده، وتهمل تعاليمه، ويترك القصاص أو تتوقف جباية الضرائب المالية، أو يترك الدفاع عن أمة المسلمين وأراضيهم. واعتقاد أن الإسلام قد جاء لفترة محدودة أو لمكان محدود، يخالف ضروريات العقائد الإسلامية، وبما أنّ تنفيذ الأحكام بعد الرسول الأكرم (ص) وإلى الأبد من ضرورات الحياة. لذا كان ضرورياً وجود حكومة فيها مزايا السلطة المنفذة المدبرة. إذ لولا ذلك لساد الهرج والمرج والفساد الاجتماعي، والانحراف العقائدي والخلقي، فلا سبيل إلى منع ذلك إلاّ بقيام حكومة عادلة تدير جميع أوجه الحياة”.
ويستدلّ الخميني بضرورة الحكومة في عصر الغيبة بطول مدة غيبة الإمام المهدي والتي قد تطول ألوف السنين ويتساءل: “وهل تبقى أحكام الإسلام معطّلة؟ يعمل الناس خلالها ما يشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ وهل حدد الله عمر الشريعة بمئتي عام مثلاً؟ هل ينبغي أن يخسر الإسلام من بعد الغيبة الصغرى كل شيء”. ويجيب بالنفي مؤكداً “أنّ كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام. ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها. وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف”.
يخاطب الخميني أصحاب نظرية الانتظار قائلاً: “لا تقولوا ندع إقامة الحدود، والدفاع عن الثغور، وجميع حقوق الفقراء، حتى ظهور الحجة (الإمام المهدي)، فهلاّ تركتم الصلاة بانتظار الحجة؟”، وذلك في محاولة للاستدلال العقلي على وجوب التصدّي للإمامة من خلال الاستدلال بوجوب الصلاة في جميع الأزمنة والأمكنة والظروف، وعدم وجود أي مبرّر يجيز التوقّف عن الصلاة.
وحول من ينوب مقام الإمام المعصوم في الإمامة، يقول الخميني: “وبالرغم من عدم وجود نص على شخص ينوب عن الإمام حال غيبته، فإن خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توافرها في أي شخص مؤهلاً إياه ليحكم في الناس. وهذه الخصائص التي هي عبارة عن العلم بالقانون والعدالة موجودة في فقهائنا في هذا العصر”.
وذكر الإمام الخميني في موضع آخر: “يرجع أمر الولاية إلى الولي الفقيه العادل، وهو الذي يصلح لولاية المسلمين؛ إذ يجب أن يكون الولي متّصفاً بالفقه والعدل”.
وقد ذهب إلى أنّ صلاحيات الفقيه هي صلاحيات الإمام المعصوم نفسها فقال: “للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة (ع)، مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق، لأن الوالي، أيّ شخص كان، هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية، والآخذ للخراج، وسائر الماليات والتصرف فيها بما فيه صلاح المسلمين”.
وهكذا نرى أنّ الخميني كان يؤمن من خلال تأويله لتلك الروايات، بأنّ ولاية الفقيه ولاية دينية إلهية، ويقول في ذلك: “إنّ الله جعل الرسول (ص) ولياً للمؤمنين جميعاً، ومن بعده كان الإمام ولياً، ونفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه، وإن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأصلية». ثم يعتبر أن على الفقهاء أن «يعملوا فرادى ومجتمعين من أجل إقامة حكومة شرعية. وفي حال عدم إمكان تشكيل تلك الحكومة، فالولاية لا تسقط لأن الفقهاء قد ولاّهم الله. وليس العجز المؤقت عن تشكيل الحكومة القوية المتكاملة يعني بأي وجه، أن ننزوي، بل التصدي واجب”.
حصر الخميني الحق في إقامة الدولة في عصر الغيبة في الفقهاء فقط، إذ يقول: “الفقهاء العدول وحدهم المؤهلون لتنفيذ أحكام الإسلام وإقرار نظمه، وإقامة حدود الله وحراسة ثغور المسلمين، وقد فوّض إليهم الأنبياء جميع ما فوّض إليهم وائتمنوهم على ما ائتمنوا عليه”.
المصدر: خلاصة من بحث هيثم مزاحم “سؤال العنف في فكر الخميني بين النظرية والتطبيق”، ضمن الكتاب 130 (أكتوبر/تشرين الأول 2017) ‘مرجعيات العقل الإرهابي: المصادر والأفكار’ .الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي، نقلاً عن موقع ميدل ايست أونلاين